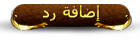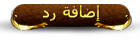نحن أهل مكة، وبالتالي نحن أدرى بشعابنا، ومستوى مستشفياتنا، وجامعاتنا، وبيئة استثمارنا، وكل شيء لدينا. نفرح بالتأكيد، حينما يحصل أي تقدم لأي منجز لدينا، ونسعد كثيراً عندما يحصل ذلك المنجز على تقدير عالمي واعتراف دولي، ولكن الفرحة ستكتمل، والسعادة ستزداد حينما يلمس المواطن التقدم في ذلك المنجز والتطور في خدمات ذلك الجهاز.
قلت في مقالة سابقة، إن هناك فرقاً شاسعاً بين النقد القاسي لجهازنا البيروقراطي والإقلال من جهوده أو إلغائها بالكامل، وبين تقويمه، وإبداء الملاحظات على أدائه بهدف التحسين والتطوير، وأتمنى ألا يكون مقالي هذا يصب في الخانة الأولى. ولكنني بدأت أضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام أمام الكثير من التصنيفات العالمية التي تمنح لبعض أجهزتنا، وهي تصنيفات تضعنا في مراتب متقدمة، بل وفي درجات نتقدم من خلالها على دول سبقتنا خبرة وإنجازاً، بل وحضوراً عالمياً. كما قلت إننا سنبقى أسعد الناس بهذه التصنيفات، ولكن ما نشاهده ونلمسه من خدمات تقدمها هذه الأجهزة التي يتم تصنيفها في مراتب متقدمة عالمياً يجعلنا نضع الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، بل وكي أكون أكثر وضوحاً، الشك في تلك التصنيفات، أو، بصورة أدق، الشك في الآليات المتبعة لتلك التصنيفات.
مع الأسف الشديد أن الحصول على تصنيفات متقدمة أصبح هو الشغل الشاغل، لدرجة أصبحتُ معها أكاد أجزم أن بعض المسؤولين وضعوا تلك التصنيفات فوق طاولاتهم، وانشغلوا بالوصول إليها، وكأنهم في امتحان يضع لكل عنصر من عناصر التقويم درجة أعلى، وكلما زادت الدرجة، زاد اهتمام ذلك المسؤول بهذا العنصر والعمل على تحقيقه. أما كيف يتحسن أداء ذلك الجهاز، وكيف يلمس المواطن التقدم فيما يحصل عليه من خدمات فهو أمر آخر قد لا يأتي في أولويات ذلك المسؤول. فالتصنيفات العالمية، على أهميتها، تركز على ما يكتب على الورق من أنظمة وقوانين، أما ما ينعكس على الواقع، فهو ما يلمسه المواطن، الذي أصبح يصاب بازدواجية كبيرة نتيجة الفرق بين ما يقدم إليه من خدمات وبين ما تمنحه تلك التصنيفات من مراتب متقدمة لبعض مؤسساتنا.
بقلم د. محمد الكثيري