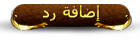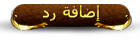لجينيات
الخريطة المقبلة لقيادة العالم 30/4/2009
مايكل شيفر ــ إعداد - محمد طاهر
في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في عام 1999، أشادت مجلة التايمز بـ"اللجنة التي شكلت لإنقاذ العالم" من كل من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت (1997 ـ 2000) باعتبار أن الولايات المتحدة هي "الأمة التي لا غنى عنها"، والتي تقع على قمة الترتيب في نظام القطبية الأحادية العالمي.
هذه الفكرة أصبحت إرثاً من الماضي بعد عقد من الزمان، ورغم أنه لا يوجد خلاف حول أن الولايات المتحدة ستظل القوى الأكبر عالميًا، نظرا لقوتها العسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية؛ فإن هناك قوى كبرى صاعدة منها الصين، والهند، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، قوى ستدفع العالم بسرعة نحو التعددية القطبية، إلى القدر الذي يجعلنا نتحدث عن عصر "ما بعد أمريكا"، خاصة وأن الأحادية الأمريكية باتت قصيرة الأجل.
وإذا كان ذلك يعود في جانب منه لسياسات خاطئة اتبعتها أمريكا خلال هذا العقد، إلا أن الأكثر بروزاً هو التغيرات العميقة في نمط توزيع وانتشار القوة خلال سنوات، وربما عقود خلت، فهناك صعود سريع لقوى دولية أخرى، تمكنت من إحداث اختلافات نسبية مع أمريكا التي أصبحت أقل قوة حالياً مقارنة بعدة سنوات ماضية.
دروس التاريخ
ترى النظرية الكلاسيكية للعلاقات الدولية أن فترات انتقال القوة (وهي الفترات الحاسمة التي تتغير فيها طبيعة النظام الدولي وتتحول من نمط إلى آخر)، والتي تحدث عندما تنتج علاقات القوة المتغيرة بين الأمم نمطاً جديداً لتوزيع القوة، هي أكثر الفترات خطورة في إمكانية حدوث انحرافات في الاتصالات والتوقعات والإدراكات والشرعية بين القوى الكبرى، ويمكنها أن تؤدي لانهيارات وخلافات على قمة النظام الدولي.
وواقعياً، ينتج المصدر الأساسي لعدم الاستقرار بشكل رئيسي من الاحتكاك أو الخلاف بين القوى الصاعدة التي تعتقد أنها محرومة من "مقعد على الطاولة"، والقوة المسيطرة التي ترفض التخلي عن مواقعها، متغاضيةً عن الحقائق الجديدة في النظام الدولي.
وتعتبر الخبرة التاريخية أكبر دليل على خطورة فترات انتقال القوة في النظام الدولي؛ فمنذ انهيار السيطرة الإسبانية خلال حرب الثلاثين عامًا (1618 ـ 1648م) وحتى الحربين العالميتين الأولى والثانية، وانهيار الإمبراطورية البريطانية، اتسمت فترات انتقال القوة بالعنف والاضطراب قبل استقرار التوازن العالمي الجديد، حيث يتعرض النظام الدولي لضغوط عندما تفشل القوى الصاعدة في أن تتولى مسئولياتها عن النظام العالمي، وتفقد القوى المسيطرة القدرة على ضمان فعالية النظام، ما يدفع القوى الصاعدة إلى السعي لسد هذه الفجوة.
وإذا كان بعض المحللين يعتقدون أن الصدام بين القوى الصاعدة وتلك المسيطرة أمر حتمي، فإنه لا يوجد شيء تلقائي أو آلي في هذه العملية، ومن ثم تصبح الخيارات والقرارات السياسية، صغيرة كانت أم كبيرة، شديدة الأهمية.
ما الذي يكون قوة عظمى؟
ثمة صعوبة تكتنف تعريف القوى العظمى في أي حقبة تاريخية، لكن بشكل عام يتحدد وضع الدولة كقوة عظمى طبقاً لقدرات مجمعة من القوة والثروة والنفوذ. وعلى سبيل المثال، اقترح كينيث والتز، عالم السياسة المعروف، خمسة مقاييس مختلفة لتقدير قوة الدولة، وهي: السكان، والمساحة، والموارد الطبيعية، والقدرات الاقتصادية، واستقرار وسلامة النظام السياسي، والقوة العسكرية.
بينما يعتبر بول كينيدي، المؤرخ البريطاني، أن حجم السكان ومعدلات التحضر ومستوى التصنيع، واستهلاك الطاقة والمخرجات الصناعية، هي أيضا مقاييس أساسية للقوة في القرن العشرين.
وإجمالاً يمكن تقسيم القوى الدولية الحالية وفقاً لمقاييس قوة الدولة فيما يلي:
القوة التقليدية
بلغ متوسط نمو الاقتصاد الصيني حوالي 10% خلال العقد الأخير، وسيتضاعف هذا الرقم خمسين مرة بحلول عام 2050، لتتخطى الصين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد عالمي، لكن الأخيرة ستبقى أغنى بسبب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمثل بلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي نسبة 8% سنوياً، ويتوقع أن تكون الهند واحدة من أكبر ثلاث اقتصادات في العالم بحلول منتصف القرن الحالي. ووفقاً لذلك، فإن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً من سيطرة أوروبا وأمريكا إلى سيطرة منطقة آسيا والباسيفيك.
وربما تظل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للصين، لكن إذا تم النظر إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 باعتبارهم كتلة واحدة، فإن حجم التجارة بين كل من الصين والاتحاد الأوروبي سيتجاوز بكثير حجم التجارة بين الصين وأمريكا. وهذا التغير في أنماط التجارة سيحدث تغيراً مماثلاً في تدفق المعلومات والأفكار والسياسة والدبلوماسية. وستقود هذه التغيرات، طبقاً لبعض الدوائر، إلى عصر "الانتصار الآسيوي" وفق تعبير الدبلوماسي السنغافوري كيشور مهبوباني، حيث تنتقل دول آسيا من دور المتفرج الذي لعبته عبر قرون، إلى دور المشارك مع الغرب في تشكيل المؤسسات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبالرغم من أن النمو الاقتصادي يستحوذ على الاهتمام كأحد العناصر الهامة لتكوين قوة عظمى، فإن القوة العسكرية تبقى المعيار الذهبي لتشكيل هذه القوة، وربما لم تشهد دولة تزايداً في قوتها العسكرية كما حدث في الصين التي حققت قفزة كمية في المجال العسكري في أعقاب التمدد الاقتصادي الكبير الذي شهدته. يؤكد ذلك تطور القدرات العسكرية الصينية، وخاصة قوة أسطولها البحري وزيادة عدد الغواصات الإستراتيجية، واقتناء غواصات ومدمرات حديثة، إلى جانب مراجعة وتعديل العقيدة البحرية الصينية لتأكيد قدرة بكين على العمل في بحار جنوب وشرق الصين، وأيضا فيما أبعد من ذلك.
وقد استرعى النمو الهائل للقوة العسكرية الصينية خلال العقود الماضية الانتباه، وأثار الكثير من القلق حول النوايا الصينية، وهو القلق الذي دفع تقريراً للبنتاجون إلى القول بأن هناك احتمال كبير لأن تدخل الصين في منافسة عسكرية مع الولايات المتحدة.
القوة النووية
يعتبر تطوير وامتلاك الأسلحة النووية مقياسا آخر للقوة العسكرية في الحقبة العالمية الجديدة، وقد تم التعامل مع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا كقوى نووية شرعية، كما جاء في معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعت عام 1970. ومع أن الهند قد أسقطت من هذا التصنيف لسنوات، إلا أن الاتفاق النووي الهندي الأمريكي مثل علامة بارزة على الاعتراف الضمني بالهند كقوة تمتلك أسلحة نووية، وما يعنيه ذلك من تكلفة وتأثير على مستقبل بقاء نظام منع الانتشار نفسه.
وهناك قوى أخرى مثل البرازيل وجنوب إفريقيا قد امتلكت برامج نووية في الماضي، لكنها اختارت ألا تطور أسلحة نووية. وفي السنوات الأخيرة، لم تعد اليابان تتحرج من الإشارة لكونها قوة نووية "افتراضية" على الأقل من الناحية التقنية، على الرغم من تخليها عن تطوير الأسلحة النووية أو القوة العسكرية الهجومية، طبقا لدستورها السلمي.
ولهذا أصبح ينظر إلى الأسلحة النووية بوصفها مؤشراً هاماً على تحول دولة ما إلى قوة عظمى (من الممكن أن تمتلك الدولة الأسلحة النووية ولا تصبح قوة كبرى، ولكن لا يمكن أن الدولة قوة كبرى دون امتلاك السلاح النووي)، ومن المرجح أن تكون هناك بعض التوترات بين قواعد نظام منع الانتشار وبين توجهات القوى الكبرى نحو تحقيق طموحاتها النووية المحتملة.
القوة البترولية
تعتبر الطاقة والموارد الطبيعية أحد الأبعاد الهامة لامتلاك القوة، وستظل الطاقة أحد الخصائص البارزة لنماذج القوة في القرن الحادي والعشرين. وفي ظل الضغوط الناجمة عن التغير المناخي، وحاجة الاقتصاديات الصاعدة للحفاظ على معدلات مرتفعة من النمو؛ فإن القضايا المتصلة بالطاقة ستكون حاسمة للدول الطامحة لوضع القوى العظمى.
وعلى سبيل المثال، ارتبطت عودة روسيا من جديد للساحة الدولية بعد عقد من نهاية الحرب الباردة بصورة أساسية بالثروات التي تجمعت لديها جراء الطلب العالمي المتزايد على النفط والغاز الطبيعي وارتفاع أسعارهما.
وتوقع السيناتور الجمهوري "ريتشارد لوجر" بزوغ عصر جديد من "القوى البترولية العظمى"، التي تعتمد في جزء من نفوذها وتأثيرها على امتلاكها حصة من النفط والغاز الطبيعي. واتجهت دول أخرى، مثل البرازيل واليابان، لتجربة بدائل جديدة للطاقة منها: الوقود الحيوي، وذلك لتأكيد وضعية القيادة العالمية من خلال تطوير تكنولوجيا جديدة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة أو إيجاد بدائل للوقود غير المتجدد.
العامل الديموجرافي
وبالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والعسكرية للقوة، يعد العامل الديموجرافي مكوناً هاماً في الحساب التقليدي لمكانة القوى الكبرى؛ فالصين والهند، الدولتان الأكثر ازدحاماً بالسكان على كوكب الأرض، تتمتعان بموارد عمالية لا تنضب، ما يوفر لهما التأثير والنفوذ على الساحة الدولية. وعلى النقيض من ذلك نجد أن روسيا تعاني، في السنوات الأخيرة، من ارتفاع معدلات الإصابة بالإيدز وتناول الكحوليات، ما نتج عنه انخفاض معدل العمر المتوقع عند الولادة إلى 65 عاماً، وانخفاض معدل الخصوبة إلى 1.4% (وهو معدل أقل من معدل الإحلال الطبيعي)، أي أن المؤشرات الديموجرافية في روسيا تشير إلى الانحدار بما يطرح التساؤل حول قدرة روسيا كقوى عظمى على وقف هذا التدهور.
شرعية القوة
يمثل الاعتراف للدولة من قبل اللاعبين الآخرين في النظام الدولي بوضعها كقوة عظمى عنصراً لازماً لتشكيل هذه القوة العظمى، فإحدى الطرق لقياس ظهور البرازيل كلاعب عالمي، يمكن تلمسها في الاعتراف المتنامي بها كأحد أعضاء النادي العالمي، وذلك بعد أن كانت مستبعدة من (مجلس القيادة العالمي). ومنذ عام 2003، حظيت البرازيل بوضع المراقب في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، كما أشار صناع القرار الأمريكيون خلال لقاءاتهم في السنوات الأخيرة إلى البرازيل كشريك عالمي وقوة إقليمية رئيسية في أمريكا اللاتينية.
هذا النوع من "الاعتراف" ليس لغواً أو عبثاً، وإنما له تطبيقاته العملية الملموسة:
أولاً: أن الاعتراف بالقوى الصاعدة وإدماجها في النظام الدولي من قبل القوى العالمية القائمة هو عنصر حاسم في ضمان أن يتم انتقال القوة بشكل سلمي وسلس.
ثانياً: يعد مجلس الأمن الدولي بمثابة الحيز أو القضاء الشرعي في النظام العالمي الحالي، والعضوية الدائمة به تضفي على الدولة مكانة القوة الكبرى. وهنا تكمن مشكلة القوى الطامحة لمكانة دولية كالهند والبرازيل واليابان، والتي ترى أن العضوية الدائمة في المجلس لم تعد تعكس التوزيع الحقيقي للقوى العالمية.
القوة في عصر جديد
خلافا لعناصر القوة الأساسية (الثروة ـ القوة العسكرية ـ البعد الديمجرافي) الهامة لوضع القوى الكبرى؛ فإن العناصر المكونة لقوة كبرى يجب أن تكون ملائمة للحقبة الجديدة والخصائص التي تميزها. ومن ثم فإن المفاهيم التقليدية، مثل الأهمية الجيوسياسية للموقع الجغرافي، والتي ركز عليها المحللون في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أصبحت أقل أهمية في عصر تكنولوجيا الصواريخ البالستية، التي جعلت فضاء القوة التقليدية محدوداً.
ومع أن العناصر التقليدية للقوة ما زالت تحظى بالأهمية، فإن حقائق العولمة والعالم الرقمي المميز للقرن الحادي والعشرين تقدم أبعاداً جديدة للقوة تسمح للدول بالتنافس على وضعية القوى الكبرى. ومن أهم هذه الأبعاد الجديدة طبيعة القوة الناعمة، وعولمة الاقتصاد، والابتكار.
في عصر الاتصالات العالمية اللحظية والمبتكرة، تلعب القوة الناعمة دوراً متزايداً في اهتمامات الدول الكبرى. والقوة الناعمة مفهوم تم تطويره من قبل جوزيف ناي، الأستاذ بجامعة هارفارد، والذي عرفها بأنها "القدرة على تشكيل تفضيلات الآخرين عن طريق مثال يجذب هؤلاء لفعل ما تريد". وتنتج هذه الجاذبية عن الثقافة الشعبية والدبلوماسية العامة وقوة الأفكار القومية. وقد ساعدت القوة الناعمة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها خلال فترة الحرب الباردة.
ويشير الكثير من المحللين الآن إلى تسويق الصين للأصول التي تشكل قوتها الناعمة، مثل كونها مكاناً جاذباً للاستثمارات، علاوة على ثقافتها المتميزة ونموذجها السياسي البديل القائم على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى. كما استفادت القوى الصاعدة الأخرى من القوة الناعمة، وظهرت البرازيل على المسرح العالمي ليس فقط لاقتصادها النشط، وإنما أيضاً لثقافتها المرحة، حيث ساعدت صورة البرازيل (وخاصة موسيقاها وشواطئها) على خلق عامل جذب اقتصادي، علاوة على تعزيز صورتها الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقد غير الترابط بين الاقتصاد العالمي والتجارة أيضاً من تركيبة المعايير التقليدية للقوة الاقتصادية وتراكم الثروة القومية؛ فحجم التجارة العالمية (محسوب بنسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي) يبلغ اليوم ضعف ما كان عليه منذ قرن، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والملكية المشتركة للشركات متعددة الجنسيات والأسهم والسندات وصكوك التأمين بين القوى الكبرى تطورت بشكل غير مسبوق؛ مما خلق تدفقات عالمية من رءوس الأموال والأفراد والسلع. ولذا إذا أصيبت سوق نيويورك للأوراق المالية بـ "البرد"، فإن أسواق لندن وطوكيو وشنغهاي "تعطس" والعكس بالعكس.
وأدى إنشاء هياكل وأدوات مالية جديدة إلى تغيير المنافع المحتملة من تركم الثروة الوطنية باعتبارها أداة لقوة الدولة، والتي لم تعد ببساطة تكمن في قدرتها على تحويل الثروة إلى قوة عسكرية. فالصين تمتلك ما يقرب من 600 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية، وتبلغ احتياطياتها من العملة الصعبة حوالي 1.9 تريليون دولار، وهو ما يعطي لها نفوذاً اقتصادياً كبيراً، حتى وإن انقسم المحللون حول كيفية تفعيل الصين لهذا المزايا المحتملة من خلال وسائل مفيدة.
وتتمثل السمة الثالثة للنظام العالمي الجديد في التركيز على القدرة على الابتكار والاختراع، وقدرة الدولة على المنافسة فيما يتعلق بتحقيق إنجازات عملية وتكنولوجية تؤدي لتعزيز القوة الاقتصادية للدولة وغيرها من الأشكال الأخرى للقوة.
وفي هذا الإطار تبقى الولايات المتحدة على رأس الدول الأخرى، حيث سجل بها نحو 53 ألف براءة اختراع في عام 2007، مقارنة بـ 28 ألف براءة اختراع في اليابان، و5 آلاف فقط في الصين.
ويفتح التركيز على الابتكار المشهد العالمي أمام لاعبين جدد يفتقدون عادة للمميزات التقليدية للقوى العظمى، مثل كوريا الجنوبية التي تعتبر رائدة عالمياً في مجالات تكنولوجيا الإنسان الآلي، والاستنساخ، والتكنولوجيا الحيوية. كما أنها في طريقها لأن تصبح تاسع أكبر اقتصاد في العالم.
هذه العناصر السابقة قد لا تكون العناصر المحددة لوضعية القوى الكبرى أو العظمى، خلال السنوات القادمة، لكن قياس قدرة الدول على تحقيق مصالحها وصياغة الأحداث من خلال
هذه الأبعاد الجديدة والبديلة للقوة سيكون عاملاً حاسماً في إدراك شكل النظام الدولي القادم.