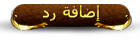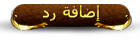الدنيا مقلوبة في بريطانيا، وبالتحديد في عاصمتها لندن، ووسائل الإعلام أقامت سرادق العزاء على تدني الخدمات.. ليست الطبية او التعليمية او الطرق او مكافحة البطالة والفقر، بل لأن المكتبة البريطانية "برتيتش لايبراري" لم تعد قادرة على توفير المقاعد لروادها، فتجد أناسا جالسين حول الطاولات يقرؤون ويكتبون ومن خلفهم طابور ينتظر قيام بعضهم ليحلوا محلهم.. نحن نفعل ذلك في الشوارع ومواقف السيارات.. كثيرون منا لا يهمهم تعطيل عشرات السيارات من خلفهم لأن الواحد منهم قدَّر أن شخصا ما دخل سيارته وسيتحرك بها ليوقف هو سيارته مكانها.. ويجلس ذاك الشخص داخل السيارة يجري مكالمة هاتفية او يقلب فاتورة الهاتف ويسب شركة الهاتف.. ويظل على هذا الحال ربع ساعة ثم يدير محرك سيارته لبضع دقائق لتسخينها وعندما يتحرك يكون من يتربص به قد عرقل حركة السير لعشرين دقيقة .. ولا عليه.. من اراد ان تثكله أمه ويدخل في هواش ومضاربة وفاصل من الردح فليتجرأ ويصيح فيه: خلي عندك ذوق ودم وخلي السيارات اللي وراك تمشي.
المكتبة البريطانية جزء من المتحف البريطاني، وافتتحت عام 1857، وفيها ألف كارل ماركس كتابه المعروف "رأس المال".. وفيه كتب تشارلس ديكنز معظم رواياته.. عندنا يقول لك شخص ما انه يقرأ يوميا لساعة كاملة وتكتشف انه يعني قراءة الصحف .. والمصيبة هي أنه وكلما ازداد عدد المتعلمين في مجتمعاتنا لا نجد زيادة موازية حتى في توزيع/قراءة الصحف.. بمعنى ان قراء الصحف صاروا يعتبرون دقة قديمة.. ومن المحزن حقا ان المكتبات العامة ليست جزءا من ثقافتنا الرسمية او الشعبية، فهي في نظرهم من الكماليات.. وفي نفس الوقت لا تجد فاعل خير يتبرع لإنشاء مكتبة عامة في بلدة ما، مع ان المكتبة لا تقل أهمية عن المركز الصحي والمدرسة.. وهناك في عدد من المدن العربية الكبرى مكتبات كبرى، ولكنها مجرد ديكور إما لعدم وجود زبائن أو لأن أنظمتها لا تسمح – مثلا – بالتسليف/الإعارة.. أو لأن ما بها من كتب لا تجتذب الباحثين عن المراجع في مختلف الميادين.
اعطوني واحدا على مائة من كلفة أي ملعب رياضي وأنا أضمن لكم تشييد مائة مكتبة وتزويدها بعشرات الآلاف من الكتب (حتى لو بعت ضميري ولهفت جزءا من المبلغ)، ولو شجعنا فقط طلبة الشهادة الثانوية والجامعات على ارتياد تلك المكتبات للمذاكرة (ويا ما هناك مئات الآلاف من الطلاب الذين لا تتوفر في بيوتهم الأجواء الصالحة للمذاكرة).. لو فعلنا ذلك فقط لكان فيه رد اعتبار للمكتبة ودورها في حياتنا.
بقلم جعفر عباس