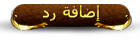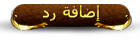دير الزور منذ أربعمائة سنة
في بدء الحقبة العثمانية في القرن السادس عشر منذ حوالي اربعمائة سنة لم يكن في إقليم الجزيرة السورية الوسطى سوى ثلاث قرى صغيرة هي الرحبة (سميت الميادين لاحقاً) ودير الزور والعشارة ، أقامت فيها السلطة العثمانية الناشئة مراكز إدارية صغيرة.
وفي العام 1696 كانت دير الزور عبارة عن قرية بسيطة لكنها مركز لواء يتبع إدارياً إلى ديار بكر ( الواقعة في تركيا حاليا ) .
منظر عام لمدينة دير الزور بداية القرن العشرين
دير الزور في بداية القرن التاسع عشر
بين سنوات 1835-1837 لم يكن هناك من قرية واحدة عامرة في وادي الفرات سوى قرية دير الزور، بينما كانت النباتات والشجيرات الشوكية المناسبة لتربية الجمال تنتشر على طول ضفاف النهر.
شكلت عشائر نجدية صغيرة مؤلفة من فرق عديدة قادمة بدورها من نجد في أوائل القرن الثامن عشر حلفاً عشائرياً فيما بينها أطلق عليه اسم العقيدات المستمد من اسم العقدة التي تشير إلى معنى الانعقاد والتضامن أو التعاقد والتناصر.
وقد انتشرت عشائر الحلف في أقضية دير الزور والميادين وأبو كمال، على ضفتي الفرات اليمنى واليسرى.
كان ضمان أمن الطريق بين حلب ودير الزور شرطاً لضمان أمن الطريق البري الذي يصل حلب مع بغداد، والذي يسير بمحاذاة وادي الفرات الأوسط، ولهذا اهتمت الحكومة العثمانية بضبطه، وإحكام السيطرة على البدو فيه ، فبنيت مدينة دير الزور على الضفة اليسرى للفرات قرب الدير( العتيق) أو( لاقا) الأمورية، و( ازورا) الرومانية، وهي النقطة التي شكلت محطة المسافرين بين البادية الشامية والجزيرة الفراتية في العهد العثماني الأول.
وقد بني المركز الإداري والعسكري للمدينة في النقطة التي يبلغ فيها الفرات أقصى حالات اتساعه
( 12كم) مشكلاً مع الزمن مصاطب مرتفعة عن مجرى النهر .
دير الزور : قائمامية ثم لواء ثم متصرفية ممتازة تابعة لاستانبول
في العام 1858 أحدثت السلطات العثمانية وحدة إدارية جديدة في المنطقة، سرعان ماتطورت إلى" قائمقامية دير الزور
" التي ضمّت الجزيرة وشمال البادية، وألحقت بولاية حلب. وتطورت هذه الوحدة الادارية في العام 1865 إلى مركز سنجق ( يسمى لواء) تحت اسم لواء دير الزور يتبع ولاية حلب.
خلال سنوات 1864-1866 قامت إدارة اللواء الفتية بتوزيع الأراض الزراعية على ضفاف الفرات بهدف تشجيع الاستقرار وتنمية الزراعة، ووزعت سندات بالملكية ( خاقانية) على الأسر حسب عدد افردها، وكانت الملكية بحدود ( بكرة) أو(12) دونماً نظرياً، لكنها كانت فعلياً تتجاوز( 100) دونماً، مقابل دفع قرش واحد عن كل دونم سنوياً كضريبة للدولة.
تمّ فك ارتباط هذا اللواء في العام 1868 عن حلب، و تم إتباعه مباشرةً إلى الحكومة المركزية في استانبول.
ثم صنّف في العام 1888 في مرحلة إعادة النظر بتوزيع الولايات كـ" متصرفية ممتازة".
وكانت متصرفية دير الزور إحدى ثلاث متصرفيات ممتازة مرتبطة بالعاصمة استانبول مباشرةً هي متصرفيات : جبل لبنان، والقدس، ودير الزور.
ضمّت متصرفية دير الزور يومئذ ما سيسمى لاحقاً بمحافظات الرقة ودير الزور و الحسكة وناحية تدمر، وقسم من الموصل، وامتدت حدود اللواء الإدارية بين منطقة عانة التي كانت تتبع يومئذ بدورها إلى ولاية بغداد العثمانية وبين مسكنة.
الجامع الكبير
بدء العمران في المدينة
بدأ عمران البلدة الجديدة منذ العام 1865، حيث كانت قد استقرت حامية عثمانية فيها بعد إخضاع عشائرها ، وبنى المتصرف العثماني داراً للحكومة وثكنةً عسكريةً ومشفى، وباشر ببناء سوق الميري، واستقدم أناساً من أورفة من أصحاب المهن والبسْتنة والكتابة للعمل فيها، واستقر معظم هؤلاء في البلدة.
وفي حدود العام 1887 كان قد تمّ بناء شبكة الاسواق التجارية التقليدية في الجهة الشرقية للدير العتيق ، حيث شكّل بناؤها امتداداً عضوياً لعمارة المدينة القديمة من حيث الاسلوب و الطابع و التقنيات، وبنيت الأسواق على أساس شطرنجي على شكل أسواق نوعية مسقوفة بقباب سريرية من الحجر والطين.
وأخذت المدينة تتوسع بمحاذاة النهر من جهتيه الشرقية و الغربية، وبدأت معالم التكوين الحضري للمدينة بالوضوح.
وفي عام 1880 ظهرت العديد من المباني الحكومية و الادارية ، كما ظهرت مناطق عمرانية جديدة مهدت لقيام أحياء الشيخ ياسين و أبو عابد و الرشدية .
وفي العام 1893 تم إحداث حي الحميدية في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة على شكل شبكة شطرنجية، وفي العام 1900 أضيفت الحويقة (حي العثمانية) إلى أحياء المدينة.
دير الزور بدايات القرن العشرين
في مطلع القرن العشرين بدأت المحاور المحيطة بالمركز بالتطور (محور الشارع العام، محور الجسر القديم باتجاه الجنوب) وانتشرت على أطرافها محلات تجارية انتشاراً خطياً لتتكامل مع شبكة الأسواق التقليدية المسقوفة .
وبني في المدينة في أواخر العهد العثماني جسر خشبي يربط بين البادية الشامية والجزيرة.
و أنشئت حديقة عامة وثانوية صناعية ومشفى وحدث ذلك بسبب حيوية بلدية دير الزور وارتفاع دخلها كثيراً بالقياس إلى المدن الكبيرة، ففي العام 1910 بلغ دخلها(3000) ليرة ذهبية سنوياً، بينما لم يتجاوز دخل كل من بلديتي دمشق وحلب(11000) ليرة ذهبية سنوياً.
تزايد السكان في دير الزور
ازدهرت مدينة دير الزور في هذه العملية التي جرت وتطورت نسبياً خلال نصف قرن ونيّف، فبلغ عدد سكانها في أوائل القرن العشرين حوالي( 9) آلاف نسمة، وارتفع في العام 1910 إلى مايقدر بـ( 15) ألف نسمة ، وارتفع حجم سكانها في العامين 1915 -1916بسبب عامل الهجرة الخارجية إليها، إلى مايقارب 20-25 ألف نسمة، وارتبطت هذه الهجرة بالهجرة القسرية الأرمنية من ولايات الأناضول الشرقية.
ففي العام 1915 قامت إدارة ولاية حلب بتوزيع اللاجئين الأرمن الذين تدفقوا عليها الى كل من حماة ودير الزور والجزيرة.عملياً كان التجميع يتم في دير الزور.
الجامع العمري
الارمن في دير الزور
وكان لهجرة الأرمن القسرية وجهها المأساوي، لكن كان لها وجه إيجابي على مدينة دير الزور، انعكس في ارتفاع عدد سكان المدينة، وبالتالي ارتفاع معدل النمو السكاني فيها. فقد كانت دير الزور مكاناً مفضلاَ للمهاجرين الارمن بسبب ضمان علي سواد بك متصرف دير الزور لحياتهم، وقيامه بـ" توفير ظروف سليمة للمبعدين، وخلال أربعة شهور ضمن علي سواد بك أمان المهجرين، وكان عقابه شديداً للبدو الذين يحاولون الاعتداء عليهم". وكان المهاجرون يستلمون إعاناتٍ ماليةً، ويستلمون الأمانات المرسلة إليهم بوساطة البريد.
وبنى المتصرف مشفى عسكرياً صممه مهندسون وبناؤون أرمن، وتحول تجمعهم إلى حي نشط بنيت فيه الأفران وأنشىء فيه سوق صغير يعمل فيه عمال مهرة.
وسمى الأرمن الحي الذي نشأ فيه تجمعهم في دير الزور بـ" السوادية" احتراماً لعلي سواد بك.
دير الزور عقدة المواصلات بين حلب و بغداد
ومنذ العام 1907 باتت حركة انتقال الأفراد وأمتعتهم بين مدينة دير الزور ومدينة حلب من جهة، وبين دير الزور وبغداد من جهة ثانية ممكنةً بواسطة شركة العربات السريعة( العربات الليلية) بين حلب وبغداد .
كانت الحكومة تزود شركة العربات هذه بأحد الجنود النظاميين ( العسكر الشاهاني)، وبمسيّر أو مرافق من البدو في رحلة السفر من حلب إلى بغداد عن طريق دير الزور .
كما شكلت دير الزور قبل الحرب العالمية الأولى طريقاً إجبارياً لمرور صفقات موسم الأغنام الثالث في أواخر الصيف من منطقة الموصل إليها ثم إلى دمشق وحلب وحمص وبيروت وأضنة ومرعش وملاطية ليتم ذبحها أو تصديرها إلى مصر عن طريق مرفأ الاسكندرون.
وتحولت مدينة دير الزور إلى ممر آمنٍ في حركة انتقال القوافل من حلب إلى بغداد عبر مسكنة والضفة اليمنى للفرات، من جهة وبين حلب- أورفة والموصل عبر منبج من جهة ثانية، مما أدى إلى انطلاق عملية استثمار تجار حلب للأرض في الجزء الأعلى من نهر البليخ في وادي الفرات .
مما يفسر العلاقات التجارية و علاقات المصاهرة بين بعض العائلات الحلبية و عائلات دير الزور .
==================================
دمشق: جوامع تاريخية
 جرن المعمودية في الجامع الأموي بدمشق
جرن المعمودية في الجامع الأموي بدمشق
تعتبر المنطقة المقام عليها الجامع الأموي بدمشق من اهم المناطق الدينية المقدسة على مر التاريخ.
ففي هذه البقعة كانت قد أقيمت في الألف الاول معابد عديدة أهمها معبد الإله "حَـدَدْ" الآرامي، إله المطر والعواصف والخصب.
وبعد انتشار الديانة المسيحية في بلاد الشام أنشأ الإمبراطور البيزنطي تيودوس الأول كنيسة في العام 379 م عرفت باسم كنيسة القديس ماريوحنا المعمدان.
وعندما تسلم الوليد بن عبد الملك سدة الخلافة الأموية في العام 705 م ضم الكنيسة الى الجامع, بعد ان كانت على عهد والده مقسومة لنصفين أحدهما جامع والآخر كنيسة.
ومن أهم معالم الكنيسة تلك الباقية إلى يومنا هذا جرن المعمودية الظاهر في الصورة، وهو جرن رخامي كبير موغل في القدم مقام داخل الجامع من الجهة الشمالية الشرقية، وتظهر على جوانبه آثار المستحاثات.
كان يستعمله المسيحيون في الأزمان الغابرة لعماد اطفالهم ومولوديهم.
 ضريح السلطان صلاح الدين الأيوبي بدمشق
ضريح السلطان صلاح الدين الأيوبي بدمشق
ضريح السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي يقع بجوار الجامع الأموي من جهة الشمال في حي الكلاسة.
وتظهر في الصورة البناء الجميل والقبة اللذين عمرهما الشاعر التركي الشهير ضياء الدين باشا إبان فترة ولايته على دمشق في العام 1876.
وتبدو يمين الصورة المئذنة الشمالية للجامع الأموي التي تعرف باسم مئذنة العروس، كما تعرف أيضاً بالمئذنة البيضاء ومئذنة الكلاسة نسبة إلى حي الكلاسة المقامة عنده.
مسجد التكية السليمانية
صورة تظهر مسجد التكية السليمانية نسبة إلى السلطان سليمان القانوني الذي أمر ببنائها في العام 1554 في الموضع الذي كان يقوم عليه قصر الظاهر بيبرس المعروف باسم "قصر الأبلق".
التكية من تصميم المعماري التركي الشهير سنان، وأشرف على بنائها المهندس الإيراني الأصل ملا آغا.
بدأ بناؤها في العام 1554 وانتهى في العام 1559 في عهد الوالي خضر باشا.
أبرز ما يميز طراز التكية السليمانية مئذنتاها النحيلتان اللتان تشبّهان بالمسلّتين أو قلمي الرصاص لشدة نحولهما، وهو طراز لم يكن مألوفاً في دمشق حتى تلك الحقبة.
ويضم هذا المسجد اليوم المتحف الحربي.
التكية السليمانية الصغرى وإلى جانبها التكية الكبرى
صورة ملتقطة للتكية السليمانية من أمام مبنى المستشفى الوطني أو مستشفى الغرباء (مركز رضا سعيد للمؤتمرات حالياً).
ويبدو في جهة اليمين من مقدمة الصورة القباب المتعددة لمبنى التكية الصغرى وقبة مسجدها المشيدة في العام 1566 في عهد الوالي لالا مصطفى باشا، وتضم التكية الصغرى اليوم سوق الصناعات اليدوية.
ويظهر في العمق من جهة اليسار مبنى التكية الكبرى الذي يمتاز بقبته الكبيرة ومئذنتيه المخروطيتين النحيلتين والتي تضم اليوم المتحف الحربي.
جامع درويش باشا وجامع السياس
جادة الدرويشية من الشمال إلى الجنوب حيث تبدو في العمق يمين الصورة مئذنة جامع درويش باشا نسبة للوالي العثماني المشيد في عهده في الفترة ما بين (1571-1574) على الطراز العثماني لفن العمارة، وما يزال هذا الجامع قائماً.
أما إلى اليسار فيبدو جامع السياس نسبة لسياسة الخيل ويعرف أيضاً بجامع القصاصي، ولا يعلم تاريخه بنائه، وقد أزيل في أواخر الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن العشرين عند تنظيم المنطقة.
============================
" لاذقية العرب " عروس الساحل في مطلع العشرينات من القرن الماضي
1- شارع فرنسا
2- قهوة في الريف
3- ثكنة الجنود
4- نبع ام ابراهيم
5- البازار( السوق الشرقي )
6- تكية الدراويش
7- ضريح الشيخ
8- البيت الابيض ( القلعة )
 9- حارة النصارى
9- حارة النصارى
يتبع