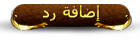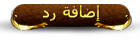الحمد لله رب العالمين الهادي بالقرآن إلى طريق مستقيم وقويم القائل في التنزيل العزيز : (إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا) ([1]) . والصلاة والسلام على النبي الرسول المربي المعلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وجعله المثال الذي ترنوا له كل النفوس الخيرة التي تسعى للوصول أو الاقتراب من نموذج الكمال البشري ، وعلى آله وصحبه أهل السبق والديانة والاقتداء ، وعلى من سار بنهجهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين
وبعد :
فبادئ ذي بدء أحسب أن الكتابة في مثل هذا الموضوع جد صعبة وشائكة وقد يضل القلم طريقه ولا يقوى على تسطير ما يعتمل في النفس ؛ ذلك لأن الموضوع ليس كغيره من القضايا التي يمكن أن يكتبها الإنسان وذلك لأمور :
أولا : إن الموضوع يتعلق بالتربية وما أدراك ما التربية التي تعني تربية الإنسان ذلك الجوهر المكنون ،و في الأثناء ذلك المركب الصعب الأغوار والمتعدد الأطوار والمعقد في الوقت ذاته .
ثانياً : إنني أحاول أن أتناول الموضوع من زاوية قرآنية ، وهذا يعقد علي الدراسة أكثر إذ ما تزال الدراسات التربوية التي ترتكز على القرآن بكراً وهي قليلة ومحدودة والموجود منها غير مبثوث للقراء حسب إطلاعي .
ثالثاً : أن الدراسة تسعى معالجة الموضوع ومعايرته في إطار جمعي واجتماعي وليس في إطار بحثي أو فردي أو نظري بل في إطار التحرك الجمعي بضبط حركة الجماعة وأقدار التحرك فكرا قبل الخطو والسير وفقاً لنموذج التربية الذي يريده منا الإسلام حصراً .
رابعاً وأخيرا : فإن الدارس يريد الاقتراب من نموذج القرآن في التربية الجماعية وهذا يقتضي الحيطة والحذر الشديد في التناول والنظر .
ولكل ما تقدم وغيره يجد المرء صعوبة بالغة في تناول الموضوع ، ولكن رغماً ذلك – وبعد الاستعانة بالله وبذل الوسع والطاقة يحاول الباحث تناول موضوع (التربية الجماعية) انطلاقاً من الرؤية القرآنية كما سيرد تسلسلاً في فقرات هذه الدراسة .
ولكن و قبل التفاصيل لا بد من الإشارة في التمهيد إلى أن المسلمين سادوا وقدموا الإبداعات في كل مجال عندما انطلقوا من محراب القرآن والسنة النبوية إذ كانوا يتقدمون إذا أمرهم بالتقدم ويتوقفون إذا أمرهم بالتوقف فكانوا رواد التغيير في العالم بعد ما غيروا ما بأنفسهم وأصلحوا ذواتهم فلم يقصدوا القرآن للاستشفاء وقراءة التعاويذ فقط وإن كان القرآن كله شفاء ولم يكونوا يقصدون القرآن للبحث وقراءته للتبرك فقط وإن كان القرآن يمكن أن يجد فيه كل باحث بغيته مقصداً ومآلاً وإن لم ينزل القرآن للدراسة والنظريات العلمية ، وإنما هو كتاب هداية للعالمين وليس كتاب دراية . وعندما تعاملت الجماعة المسلمة الأولى مع القرآن من زاوية الهداية والتطبيق وتحويل القيم إلى سلوك عندها فقط تحقق النصر وتحققت الرفعة والسؤدد للمسلمين ، وتحققت القيادة السياسية ، والريادة العلمية عندما أصبحوا قرآناً يمشي على الأرض وكانوا منارات للهدى وقبلة للعالمين ، عاشوا للفكرة وعاشوا للمنهج الذي يحلمون ولم يعيشوا لذواتهم حتى اختلط على (الرآي) المثال والواقع وكانت النفوس تتساءل هل كل ما نقرأه في التاريخ الإسلامي من هذه القامات الشوامخ دارسي التاريخ الإسلامي من الرجال، هم رجال آدميون حقاً تخرجوا في مدرسة هذا القرآن التي بين يدينا ؟ أم إن ذلك كان ضرباً من الخيال أم إن ثلة من عالم الملائكة جاءوا لنصرة الحق ؟!
ولكن تنتفي كل هذه الخيالات وهذه الوقفات عندما نجد سير أولئك في التاريخ الإسلامي مدونة وحاضرة لكل ما كان ، فلم يستثن كتّاب التاريخ من سير الأعلام حتى لحظات الانحطاط ، ولحظات الدنو من الذات الأرضية والابتعاد عن الذات العلوية أو السماوية سواء كان ذلك في تاريخ الأمة أو الأفراد الذين بنيت الأمة على سواعدهم فكيف كان ينظر أولئك إلى القرآن الكريم؟! وما الذي يمكن أن يعمله القرآن في النفس البشرية ؟ وهل يمكن صياغة الفرد المسلم وفق المنظور القرآني من جديد ؟ هذا ما سوف يتضح من خلال هذه الموضوع.
أما عن نظرة السلف للقرآن فلا يتسع له هذا الموضوع ولكن قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المسلمين وقفوا طويلاً عند إعجاز القرآن وبلاغته ، ومن قبل ذلك عند تأويله لفهم معانيه والعمل بها بدءا بابن عباس حبر الأمة وكل دارسي القرآن الكريم قديماً وحديثاً .
وهذا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في وصف القرآن الكريم: ( كتاب الله الذي فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن ، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا َهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ) من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم )([2]).
لا أجدني مضطراً للتعليق على هذا الكلام الرائع الذي يشع نوراً وبياناً وكأنه قبس من نور الذكر الحكيم !
وقال شيخ الإسلام رحمه الله ( والقرآن شفاء لما في الصدرو ومن قبله أمراض الشبهات والشهوات،ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل يزيل أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح الفكر فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محباً للرشاد مبغضاً للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضاً للرشاد ) ([3]).
بمثل هذه النظرة للقرآن كانت النفوس والعقول تتعامل ولذلك ارتفعت الأمة حتى بلغت مجداً في زمن ليس طويلاً إذا ما قيس بمقاييس الصعود الحضاري للأمم من قبل ، فكانت الجماعة المسلمة الأولى أمة رسالة ودعوة ومقصد وغاية نبيلة.
قال أحد الباحثين المعاصرين عنها :
( ولقد كانت خير أمة في تاريخ البشرية كله وحوت من ألوان العظمة في كل اتجاه مالم يجتمع لأمة أخرى في التاريخ بهذه الوفرة وذلك التعدد وتلك الآفاق عظمات سياسية وإدارية ،وعظمات نفسية وعظمات روحية وعظمات من كل نوع وفي فترة وجيزة من عمر الزمن كأنها لحظات ، وتلك الأمة هي التي وضعت أسس التاريخ الإسلامي المقبل كله ورسخت قواعده في الأرض، بما قدمت من مبادئ وقيم ومثل عليا مطبقة في عالم الواقع بصورة فريدة في التاريخ صورة يلتقي فيها المثال والواقع فلا تكاد تعرف من ورعة العظمة المذهلة أيهما الواقع و أيهما المثال) ([4])
كيف لا تكون كذلك هي الأمة التي تربت على يد خير معلم وخير مرب وهي التي حولت القيم النظرية إلى سلوك عملي في حياتها اليومية وهي التي وصلت مرحلة الكمال البشري والاستقامة المنهجية ما شهد به الأعداء قبل الأتباع وكان سلوك المسلمين وتعاملاتهم وأخلاقهم هو ما يدفع الناس إلى الإيمان وإلى البحث عن هذا الدين العظيم الذي يخرج العظماء من الناس كانوا يملكون أنوار الوحي الذي يمشون به بين الناس كما قال عنهم الرب عزوجل : ( أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) ([5]). وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد بينهم مثل قوله تعالى : (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) ([6]). ونحن نقرأ (قيماً) بكسر القاف المعجمة و بالطبع الذين يتذوقون المعنى الجمالي والمعرفي في هذه الدلالة يعرفون مدى الارتباط بين هذا المعنى وموضوع التربية ، ثم تأمل كم مرة وردت لفظ ( رب ) في هذه الآيات لتدرك معنى هذه الرعاية والعناية والحياطة الإلهية لهذا النبي العظيم وهذه الأمة العظيمة ، وستتضح للقارئ معنى الرب تربويا عند مناقشة مفاهيم ومصطلحات في هذه الدراسة فيما بعد. كيف لا تخرج هذه الأمة العظيمة وهي تعبّ من معين هذا القرآن العظيم فكراً وسلوكاً ؟ إن القرآن قد حوى كل أنواع الكمالات والهدايات استيعاباً وتجديداً .
فهل كان جيل الصدر الأول من هذه الأمة منعزلاً عن واقع مجتمعه ، يعيش في صومعات وكهوف وأديرة وأضرحة ؟! أم كان ينفعل ويتفاعل مع واقع مجتمعه وأحياناً تتغشاه ما يتغشى كل إنسان عندما يخلو ولو قليلاً إلى بشريته ؟!
هذا ما سيتضح من خلال النماذج التي سترد في هذه الدارسة ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى إن السمة الأبرز ضمن سمات أخرى هي سمة التوازن مع التمايز ، بين الأمة وبين مطالب الروح والجسد وبين الاتصال والانفصال وبين الانتماء في ظروفه وملابساته أي كانوا يعيشون حياة الإنسان بكل ما تعني هذه الكلمة ولكن لا يخرجون بها عن موجهات الوحي وإرشاداته وهداياته، فلم يكن مجتمعهم ملائكة في المساجد شياطينا في الأسواق ، ولم يكونوا أشداء على بعضهم البعض ضعفاء أمام شهواتهم ونزواتهم ومن قبل خصومهم وأعدائهم !! يقول محمد قطب عن سمة التوازن التي كانت في مسيرة الجماعة الأمة ( التوازن - وهو سمة من سمات الإنسان الصالح- معنى واسع وشامل يشمل كل نشاط الإنسان والوصول إلى التوازن في حياة الإنسان المتعدد الطاقات والاتجاهات ليس أمراً هيناً في الحقيقة فهو جهد جاهد يستغرق حياة الإنسان كلها ويشمل كل لحظة من لحظات هذه الحياة جهد التوفيق بين الضرورات القاهرة والأشواق الطائرة جهد التوفيق بين ما يجب أن يكون ، وما يمكن أن يكون جهد التوفيق بين مطالب الفرد الواحد المتعددة والمتعارضة وبين مطالب المجموع جهد التوفيق بين هذه العاجلة والعمل للآجلة ، جهد التوفيق بين هذه اللحظة وهذا الفرد وهذا الجيل وبين جميع اللحظات وجميع الأفراد،وجميع الأجيال –جهد جاهد يستغرق كل طاقة الحياة ) ([7]) .
وقبل هذا وذاك فهو إنسان وفق ما ذكر قبلاً وليس ملاكاً يمشي بين الناس وبالتالي لا بد من التوفيق والبحث عن سبل الهداية والمقاربة لبلوغ الكمال ، ومن رام الخلاص المحض والنقاء المحض والصفاء في عالم الإنسان فقد طلب المستحيل!.
قال ابن عاشور : ( والخلو من المعاصي لا يستتب إلا لقليل ، كما قال تعالى : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ) ([8]) .
ولكن ثمة أسئلة يمكن أن تطرح هنا هل النخب القائدة هي التي تصنع التغيير ؟ أم أن الأمة بجموعها مدعوة لصناعة التغيير في كل مستوياتها ؟وإذا كان كذلك فأين مكامن التحريك وكيف يمكن أن تفجر الطاقات ؟! وكيف يمكن أن يصنع الرجال الراوحل الذين يعدلون عشرات بل مئات ممن هم دون ذلك ؟!
وما الذي يعيد لأمتنا هيبتها عندما تتعرض كما هو الحال إلى حالة من ذوبان الشخصية وغياب السلطة الجامعة ؟! تقول منى أبو الفضل : ( الفردوالأمة ليس بالضرورة أن يكون عمر بن عبدالعزيز ليقيم مسار دولة ولو لفترة ولإصلاح الدين لينشل أمة من مذلة وهوان ، ولا أبو حامد الغزالي وهو يعيش ملحمة إحياء علوم الدين ولا ابن تيمية وهو يراوح بين السيف والقلم حاملاً قلب هذه الأمة وعرضها في جوفه ولكن يعيش هذا الفرد في كل عصر وكل مصر دون اشتراط الشهرة والألقاب ، ولكن يكفي أن تهب رياح الخطر على هذا الدين ومستضعفيه ، فإذا الأمة تجده على ثغرة وقد خرج فرداً أو معه نفر من أولي العزم وقد جاءوا رجالاً يسعون في الله وقد تنادوا من كل فج عميق ) ([9])
ويقول أحد الباحثين المعاصر أن الرؤية القرآنية تعتمد في التغيير على القدرة المكثفة على الفاعلية ، والتغيير من خلال الإيمان وليس بالكثرة ، وإن القرآن يضرب مراراً على قاعدة الأرقام ويستبدلها بقاعدة الفعل التاريخي النوعي لا الكمي([10]) .
ثانيا : مفاهيم ومصطلحات تربوية
وقبل إيراد المصطلحات التربوية ذات الصلة لا بد من تعريف مصطلح ( المفهوم ) الذي يتردد كثيراً عند الدارسين فماذا يقصدون بلفظ ( المفهوم ) ؟ .
المفهوم لغة:
يراد به المعلوم أو مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى ( كليّ ) لشيء ما جماداً أو إنساناً أو حيواناً وتدور مادته اللغوية حول :جودة الاستعداد الذهني للاستنباط وحسن تصور الأمور ، وحسن تصويرها للغير ، والتفاهم المتبادل وحسن تصور المعنى([11]) .
واصطلاحا:
يراد به : الصورة الذهنية التي تجمع بين متغيرات ثلاثة : ذهني ، ولفظ معبرة عن ذلك الشيء ) ([12])
وما يرد في هذه الدراسة لا يخرج عن دلالات المفهوم سواء كان في إطاره الذهني المتصور أو الشيء المحسوس أو كانت الألفاظ المعبرة عن الشيء وهو ما يعرف أي (المفهوم )، عند اللغويين بظاهرة التواضع في اللغة فإن أي أهل لغة يتواضعون فيما بينهم لإطلاق الألفاظ سواء كان في إطارها الذهني المتصور أو الشيئ المحسوس أو كانت الألفاظ المعبر بها عن الشيء والمسميات والدلالات على الأشياء المتواجدة في بيئتهم أو المتوارثة من ثقافتهم وبالتالي عندما يطلق لفظ ما على الشيء المعين ، فإن أهل ذلك المصر لا يجدون صعوبة في فهم المفهوم بل الدلالات وظلال ومغازي الألفاظ وإيحاءاتها وتندرج مصطلحات التربية، ومشتقاتها في السياق المفهومي ذاته.